
العقيد الركن م. ظافر مراد
تنتظر دول العالم والكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات والشركات الإقتصادية نتائج الإنتخابات الأميركية القادمة، وتنظر إليها وكأنها إستحقاق وطني أو حدث له علاقة بمستقبل أي منظمة أو مؤسسة أو شركة كبرى. وفي الحقيقة أن هذا شيء طبيعي ومنطقي، كونه يستند إلى وعي الجميع لحجم ومقدار التأثير الذي يفرضه سلوك وأسلوب الرئيس الأميركي الجديد، وكيفية إدراج الأولويات وتصنيف الإهتمامات وإتخاذ القرارات الهامة على المستوى الدولي الأمني والإقتصادي.

أكَّدت المناظرة بين الرئيسين الأميركيين، السابق “دونالد ترامب” والحالي “جو بايدن”، والتي استضافتها شبكة CNN، أن حظوظ الأخير بالرئاسة القادمة ضعيفة، وأن هناك تغييراً جذرياً قادماً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه عدة قضايا عالمية، وستأتي نتائج هذه الإنتخابات متقاطعة مع نتائج الإنتخابات الإيرانية التي قد تُنتج نجاح الإصلاحيين من خلال مرشحهم “مسعود بزشكيان”، والذي في حال قدومه سيخفف من حدة التوتر مع الغرب، ومن الممكن حينها التوصل إلى نسخة جديدة من الإتفاق النووي الإيراني، مع ترتيبات في منطقة الشرق الأوسط لتخفيف التوتر هناك.
أثبتت السياسات الخارجية الأميركية بشكلٍ عام، أنها سياسات مُخططة بعيدة المدى، ولا تتوقف أو تتغير ثوابتها (الأهداف والنهايات المطلوبة تحقيقها)، عند قدوم رئيس جديد وإدارة جديدة إلى البيت الأبيض، ولكن قد يتم تغيير الإسلوب الإستراتيجي وطريقة التنفيذ، والذي يتضمن تبديل الأولويات أيضاً، فالتخطيط الإستراتيجي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار تحقيق التوازن والتناسب بين ثلاثة إعتبارات أساسية، وهي أولاً النهايات أو الأهداف، أي ما يجب تحقيقه، وثانياً الوسائل والموارد، وهي القدرات والإمكانيات المادية والمعنوية المتاحة، أي جميع عناصر القوة الوطنية، وثالثاً وأخيراً، الطرق والأساليب في إستخدام هذه الوسائل لتحقيق الأهداف النهائية المطلوبة، وعادة ما يتم تغيير الأساليب والطرق عند فشلها أو تعثرها، بأساليب أكثر تناسباً مع الظروف المستجدة، وأكثر فعالية في مواجهة المخاطر والتهديدات الماثلة. لذلك فإن تغيير الإسلوب والذي يظهر من خلال بعض المتغيرات في السياسة الخارجية، لا يعني تغيير النهايات والأهداف المطلوب تحقيقها. لذلك قد يكون المجيء بترامب إلى البيت الابيض، هدفه تغيير الأسلوب والتراجع عن بعض الإلتزامات، والإنخراض في قضايا أخرى أصبحت أكثر أهمية وتقدمت في الأولوية على سابقاتها، والجميع يعرف أن التأثير في الرأي العام الأميركي، وبالتالي التأثير في نجاح مرشح على حساب آخر، هو بيد مجموعات الضغط التي تقبض على وسائل الإعلام، وتؤثر في آراء أعضاء الكونغرس، وتدير الدعاية السياسية لأهداف متعددة، أبرزها تحقيق الأرباح المادية واكتساب مزيداً من النفوذ والتأثير في عواصم القرار وفي قرار العواصم، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود عدد كبير من مجموعات الضغط و”اللوبيات-Lobbies” وأبرزها اللوبي اليهودي وهو الأكثر تأثيراً وفعالية في صناعة القرار الأميركي، ولكن هناك أيضاً “لوبي عربي” و”لوبي إيراني” وحتى “لوبي صيني” وكل يعمل بإتجاه تحقيق مصالح وأهداف الجهة التي يتبع لها.
إن أبرز القضايا التي ستتأثر بشكلٍ جذري في حال وصول “دونالد ترامب” إلى رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، هو المسألة الأوكرانية وتقديم الدعم لهذا البلد ليدافع عن نفسه في وجه الهجوم الروسي، وعلى الأرجح أن الدعم العسكري والسياسي الأميركي سيتراجع بشكلٍ كبير، وحينها ستُترك أوروبا لتقرر في شأن إستمرارها بهذا الدعم، وعلى الأرجح أنها ستتراجع شيئاً فشيئاً عنه، وستعمل بالتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة على إيجاد تسوية منطقية ومقبولة لهذه الحرب، فالحرب الروسية-الأوكرانية وصلت إلى مرحلة صعبة وخطيرة، وباتت على شفير مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا، وهذا ما لا يريده أحد، كون الكلفة المرتقبة لأي مواجهة من هذا النوع، ستكون أعلى بكثير من المكتسبات التي يمكن أن تحققها الولايات المتحدة. والنتائج الحالية تُعتبر مرضية ومقبولة بالنسبة للولايات المتحدة، فقد استفادت شركات السلاح الأميركية من بيع الأسلحة للدول الأوروبية بشكلٍ كبير، وضمنت عقود تسليح لما يزيد عن عشرة سنوات مستقبلاً بمئات مليارات الدولارات، ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI”، تمكنت الولايات المتحدة من زيادة صادراتها العالمية من الأسلحة بنسبة 17% في الفترة بين العامين 2019 و2023 مقابل الخمس سنوات التي سبقت، كما ارتفعت حصة الولايات المتحدة في تجارة الأسلحة الدولية بشكل ملحوظ من 34 إلى 42%. على مستوى العالم، وكانت حصة الأسد للدول الأوروبية التي ضاعفت وارداتها من الأسلحة الأميركية في هذه الفترة. وتمكَّنت الولايات المتحدة من خلال زج أوروبا في دعم أوكرانيا ومواجهة روسيا، أن ابعدت الدول الأوروبية إقتصادياً عن روسيا، على الرغم من خسارة هذه الدول في مجالاتٍ عديدة، أبرزها تأمين موارد الطاقة، وباتت هذه الدول أكثر إلتصاقاً أمنياً وإقتصادياً بالولايات المتحدة الأميركية، وازدادت تبعية لها وإتكالية عليها، ما يضمن عدم تمكُّنها من تكريس ذاتها كقوة عسكرية وإقتصادية منافسة للولايات المتحدة مستقبلاً، وهذه نقطة هامة، حيث أن الإقتصاد الأوروبي يزاحم الإقتصاد الأميركي في الأسواق العالمية، لا سيما في مجال بيع الأسلحة وطائرات النقل والسيارات والعديد من المعدات الصناعية والزراعية. أما بالنسبة لليورو، فهو العملة الوحيدة المنافسة للدولار الأميركي، حيث يأتي في المرتبة الثانية تداولاً بعد الدولار في التجارة العالمية.

سيعود ترامب في حال نجاحه في الإنتخابات المقبلة، إلى سياسة مواجهة الصين تجارياً، كرجل أعمال ضليع بقضايا الإقتصاد والتجارة، وسيعيد مراجعة الميزان التجاري معها، وسيفرض شروطاً جديدة عليها، أما في المجال العسكري ومسألة تايوان، سيكون أكثر تساهلاً وانفتاحاً من إدارة بايدن، على الرغم من أنه لا يوجد الكثير ليتم تغييره في العلاقة مع تايوان.

أما في مسألة الشرق الأوسط، فهذه المنطقة هي منطقة تأثير واهتمام اميركي من الدرجة الأولى، ولا يمكن لها أن تتخلى عنها أو أن تسمح بتراجع نفوذها فيه، وعلى الرغم من تعدد خصومها هناك وغموض العلاقة معهم، إلا أنها تحاول في مكان ما التوصل إلى تسويات مؤقتة ومنع أو تأجيل أي مواجهة عسكرية معهم، وبالنسبة لغزة والحرب بين إسرائيل وحماس، فالمسألة محسومة ولن تنتظر الإنتخابات الأميركية، وحكومة نتانياهو وعلى عكس ما يقال، إستطاعت تحقيق بعض أهدافها، وأبرزها تدمير غزة وإدخال الفلسطينيين هناك في دوامة من الدمار والبؤس والفقر لعشرة سنوات على الأقل، كما أن هذه الحكومة تدرك أن القضاء على تنظيم له فكر عقائدي مقاوم مثل حماس، هو مسألة معقدة وتكاد تكون مستحيلة، وما يجري حالياً هو محاولة خلق واقع يجعل بيئة حماس الشعبية تنتفض على قياداتها وتنسحب من ولائها لها، ويأتي تحرير الرهائن في المرتبة الأخيرة من أهداف حكومة نتانياهو، والتي برحيلها، كما هي العادة وكما هو مخطط له، سيتم طمس ونسيان كل الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبتها، وستأتي حكومة جديدة تعيد إصلاح الفوضى التي تسبب بها نتانياهو، كما أن هناك نقطة هامة يجب الإقرار بها، وهي أن الإبقاء على الخلاف الفلسطيني الداخلي هو مصلحة استراتيجية لإسرائيل تفوق إعلانها أي إنتصار مزعوم على حماس، وبالتالي على الأرجح، هي لن ولا تستطيع القضاء على فكر حماس السياسي وعقيدتها العسكرية، وسترضى ببقائها ضعيفة، حيث تراهن على مواجهات وخلافات فلسطينية داخلية جديدة في “اليوم التالي” بعد نهاية الحرب، ما يمنحها فرصة للإفلات من أي إلتزامات تجاه الفلسطينيين ومن فكرة حل الدولتين، ولا يجب أن ننسى أن مصلحة إسرائيل تقضي بتغذية التناقضات وتأزيمها والإبقاء عليها في محيطها الشرق أوسطي.
أما في ما خص الجبهة الشمالية، فإسرائيل تريد إتفاقاً جديداً يغير الواقع، ويكون أكثر ضمانة لها، وهذا يصعب تحقيقه عن طريق الدبلوماسية، بل يتطلب عمل كبير و”حملة عسكرية” لفرض واقع ميداني جديد، يتم بعده التفاوض من خلال عملية سياسية تشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية، وما يهم الأخيرة هنا، أن تبقى المواجهة المرتقبة، والتي تكاد تكون حتمية وبعد حوالي اسابيع قليلة (أقله بعد صدور نتائج الإنتخابات الإيرانية وبعد الإنتهاء من عملية رفح)، ضمن السياق المنضبط، وأن لا تخرج عن السيطرة وتؤدي إلى حربٍ شاملة، وفي هذه الحالة ستكون المواجهة عبارة عن تبادل كثيف لضربات نارية عن بعد، واستهداف لمراكز قيادة ومسؤولين ولمواقع حساسة ومنشآت هامة، وستتسبب بالكثير من الدمار، وربما مع إجتياح بري قد يكون محدوداً أو عميقاً، وتتحضَّر إسرائيل لخوض هذه الجولة بكامل قدراتها العسكرية والتكنولوجية، ويُخطيء من يظن أن المسألة عبارة عن حرب نفسية، فإسرائيل مهزومة معنوياً وسياسياً، وتحتاج إلى فعلٍ كبير لإسترداد هيبتها في المنطقة وإعادة بناء سمعة جيشها المنهارة، وعلى الرغم من الإنهاك والخسارات التي أُصيب بها الجيش الإسرائيلي، تبقى إحتمالات شن الحرب على لبنان كبيرة، وتكمن المعضلة الرئيسية التي تواجه إسرائيل في هذه الحرب، في كيفية “تحييد” عدد هائل من وسائط إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في الضربة الأولى التي ستكون فجائية ووماثلة لما حدث عام 1967، ومن المرجح أن تعتمد إسرائيل في ذلك على كامل قدراتها الجوية والصاروخية ( صنف موقع Global Fire Power إسرائيل في المرتبة 17 في ترتيب القوة العالمية للعام 2024، مع 612 طائرة حربية مختلفة المهام)، وعلى الرغم من ذلك، تعلم إسرائيل أن قدرات حزب الله العسكرية كبيرة جداً ومتطورة، وتعتمد أساليب مفاجئة وغير متوقعة، لذلك هي تستعد للأسوأ، وما يطمئنها بعض الشيء، هو الوجود العسكري الأميركي الكبير والتعزيزات الغربية في المنطقة. والجدير ذكره هنا، أن الطرفان يعلمان أن هذه الحرب لن تقضي على الآخر، بل هي كباش دموي جديد ومفروض، سيستعرض كل طرف قوته فيه، ولكن مع الخروج منه بأقل خسائر ممكنة، وبعدها ليس المهم من يعلن إنتصاره، بل المهم طبيعة وبنود الإتفاق الذي سيتم التوصل إليه، والذي سيكون وكالعادة، برعاية أممية.
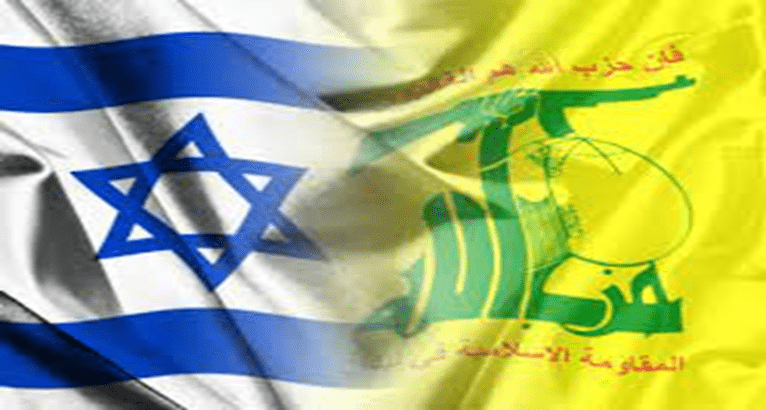
تبقى مسألة حماية سلاسل الإمداد والتوريد والتجارة العالمية في البحر الأحمر، قضية هامة لا تخص فقط إسرائيل والولايات المتحدة، بل معظم دول العالم، وفي الوقت الراهن لا يوجد حل لمنع الحوثيين من استهداف المصالح الإسرائيلية والغربية في هذا البحر من خلال قدراتهم العسكرية النوعية، وفي الوقت الذي تعتقد فيه الإدارة الأميركية أن هذا الإستهداف سيتوقف بعد إنتهاء العمليات العسكرية في غزة، تبقى إحتمالات التصعيد واردة في حال شنت إسرائيل الحرب على لبنان، وفي هذه الحالة قد يصبح تحالف “حارس الإزدهار” قوة غير مجدية، ما يستدعي إنشاء آلية جديدة لحل هذه المعضلة.
يكاد كل شيء يحدث في العالم، أن يكون مرتبطاً بطريقة ما بسلوك الولايات المتحدة الأميركية وسياستها الخارجية، فهذا البلد يمتلك الكثير من أدوات الهيمنة وأدوات التأثير في الأحداث العالمية، وفي نفس الوقت هو يقدم نماذج جذابة مبتكرة في النقد الذاتي للسياسات الخارجية، ويقر بالأخطاء المرتكبة فيها، وهذا يحدث بتوالي الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، ونعطي نموذجاً ما حصل في العراق حيث تم الإقرار بالفشل في تمكين السلطة الجديدة وفي تأسيس نظام موالي أو محايد لا يشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة، وكذلك الأمر في أفغانستان، عندما انسحب الجيش الأميركي بشكلٍ مفاجيء و”مخزي” وفقاً لمسؤولين أميركيين، فتسلمت طالبان الحكم هناك، وهذا ما سيحدث على الأرجح في المسألة الأوكرانية، بعد إستنفاذ كافة الأدوات والوسائل في إدارة الصراع والتأثير فيه، وتكمن المشكلة أن تداعيات هذه الأخطاء الهائلة يتم تحميل نتائجها إلى أطراف ودول أخرى، حيث تكون الأثمان باهظة جداً والتداعيات لا يمكن إصلاحها.










